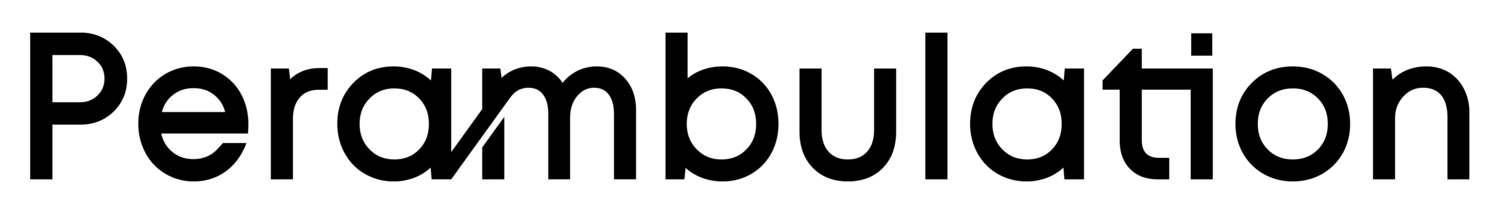خارونيون: بوابة أنطاكية إلى العالم السفلي
خارونيون: بوابة أنطاكية إلى العالم السفلي
إلى ب. ي.
"هذا الارتباط المزعوم بين «خارونيون» و«خارون» هو ليس إلّا خيال داخل حقيقة داخل خيال داخل مصادفة."
Fig 1. The Charonion, Antioch
من جهة يسار الكنيسة، تسلّقنا الصخور على ارتفاع حوالي مائة متر مُحاطين بالشجيرات والرُّكام المبعثَر، حتّى وصلنا إلى النَّقش التاريخي الضّخم المعروف بإسم «خارونيون». لا يشبه هذا المَعلَم المعابد القديمة التي يمكن للزائر أن يتخيّلها، كمعابد أرتميس أو أسكليبيون المفصولة عن العالم بأرخبيلٍ من الزمن. بل هو نصب تاريخي مُخَربَش بالطّلاء الأحمر ومتروك في حالةٍ تعليقٍ وإبطال.
كل شيء في أنطاكيا منقطع عن ماضيه لدرجة أنه، وبدون تعليمات دقيقة، لا يمكننا إدراك مدى قرب الجدار السلوقي وساحة أغورا من أنطاكية ونهر العاصي – التي كانت تشكّل مقر ملوك سوريا اليونانيين – من المغارة والنصب التاريخي. إسم «خارونيون» هو إشارة إلى شخصية «خارون» الميثولوجيّة: هو رسول ملك العالم السّفلي «هاديس»، الذي يحمل أرواح المتوفّين حديثاً الذين استوفوا طقوس الدفن على ضفاف نهر «ستيكس» (أو أخيرون)، للعبور من عالم الأحياء إلى العالم السفلي. وفقاً للشاعر «كاليماخوس»، كان يتم أحياناً وضع قطعة من النقود في فم أحد الأموات كثمنٍ للعبور (المقطع 278).
في الوحدة السّرديّة العامة (mytheme) للرحلة نحو العالم السُّفلي، يطوف البطل في العالم السفلي، ولكنه يعود حيّاً على متن قارب «خارون». مع ذلك، وفي النسخة الأكثر إقناعاً من هذه الرواية، نرى، وبشكلٍ مثيرٍ للدهشة، نرى أن «خارون» غائب: في رحلته إلى العالم السفلي، ومن أجل أن يأخذ نصيحة النبي «تيريسياس» في أرض الموتى، توجّه الساحرة «سيرس» – في الأوديسة الحادية عشرة – أمراً إلى «أوديسيوس» بأن يربط سفينته في المحيط الهائج والدوامي وأن يتوجّه مباشرةً إلى العوالم الدنيا. رحلة «أوديسيوس» نحو العالم السُّفلي هي أيضاً نكروماسيّة (nekya)، وهي الطّقس التي يتم من خلاله استدعاء الأشباح ومساءلتهم عن المستقبل، بعد قطع حلق خروفَين وإغراق الدم في الحفرة.
بيد أن هذا الارتباط المزعوم بين «خارونيون» و«خارون» هو ليس إلّا خيال داخل حقيقة داخل خيال داخل مصادفة. فالاعتقاد بأن أنطاكية القرن السادس الميلادي مرتبطة بنُصبِ «خارون» ليست باطلة تماماً، وإنما هي إدماجٌ للحقيقة والخيال صاغه مسافرون كانوا قد وقعوا على نُصبِ «خارونيون» في أوائل القرن التاسع عشر، واستندوا إلى مصدر واحد ألا وهو الكرونوغرافيا التي وضعها المؤرخ السوري جون مالالاس في القرن السادس الميلادي، والتي يصف فيها مجموعة من الأحداث التي وقعت خلال انتشار أحد الأوبئة. ففي القرن الثاني قبل الميلاد، وفي عهد ملك الإمبراطورية السلوقية الهلنستي «أنطيوخوس الرابع الظاهر»، قيل أنه وباء اجتاح المدينة، وبعد وفاة الكثير من الناس، أمر الساحر «لايوس» بأن يتم نحت صخرة في أعلى الجبل بوجهٍ ضخمٍ يوجّه نظره نحو المدينة.
يضيف مالالاس أن «لايوس» حَفَرَ على الصخرة نقشاً كان كفيلاً بوضع حد للوباء، وأنه، وحتى يومنا هذا – يتكلّم عن عصره – يُطلق الأنطاكيون على هذا القناع اسم «خارونيون»، وهو مطابق للتعبير اليوناني المستخدَم لتسمية الكهوف والمغارات والحفر والآبار التي تنبعث منها الغازات السامة، إلا أنه لا وجود لها في ضواحي أنطاكية النشطة جيولوجياً. لم يتم العثور على أي دليل على مثل هذا التدوين المنقوش، كما أن مالالاس قد حذف المحتوى الذي يتناول الحديث عنه.
يتكون النُّصب من هيئتَين: تمثال نصفي عملاق وشخص يقف على كتفه الأيمن. يرتدي التّمثال النّصفي حجاباً مزدوجاً أشبه بوِشاحٍ مزدوجٍ ذي أطرافٍ مجدولةٍ تستريح على كتفَيه. غير أن معظم تفاصيل النَّحت أصبحت مفقودة اليوم، دون معرفة ما إذا كان السبب هو التآكل بفعل مرور الوقت، أو التّخريب المتعمّد الذي حصل في العصور اللاحقة ضد دور العبادة الوثنية. من الممكن أيضاً ألّا يكون النصب قد اكتمل أبداً، أو ربما هُجِرَ بعد أن انتهى الوباء؟
Fig 2. Cave Church of Saint Peter
من المرجح أن يكون «خارونيون» مزيجاً من إلهة «كوبيلي» المُتَهَلّنة، الإلهة الجبل الفريجية، والإلهة السورية «أترعتا»، وهي الإلهة الأهم في شمال بلاد الشام والتي كان يطلق عليها الرومان إسم «الإلهة السوريّة». إذا كان قد تم بناؤه بالفعل في القرن الثاني قبل الميلاد، فإن «خارونيون» أنطاكية هو المَعلَم الأكثر شبهاً بالمعابد الأناضوليّة للإلهة «كوبيلي»، والمشيّدة في الهواء الطلق.
أما الهيئة التي نراها واقفةً على كتف التمثال النّصفي فهي على الأرجح «تيكه»، إلهة الحظ عند اليونانيين، إبنة أفروديت وهرميس أو زيوس، ورمز مدينة أنطاكية، والتي وفقاً للمؤرّخ «پوليبيوس»، هي الإله المسؤولة عن الأحداث غير القابلة للتفسير. لكن تاريخ عبادة الإلهة «تيكه» في أنطاكية أكثر تعقيداً من تاريخ إلهة مجلوبة خلال العصر الهلنستي المضطرب والعاصف (كان هناك عدد من المدارس المختلفة في عبادة الإلهة «تيكه»).
ترك الحضور الحيثي الطويل الذي امتد من القرن الرابع عشر حتى القرن الثامن قبل الميلاد، والذي سبقته حضارة الـ «ماري»، آثاراً كثيرة في المنطقة التي سكنتها الشعوب السامية والحورية. مع بداية العصر الهلنستي، ومع إدخال العناصر الثقافية اليونانية، اندمجت معتقدات الشرق الأدنى والأناضول مع الأسماء اليونانية، بينما احتفظت بسماتها المحليّة القديمة. لهذا النوع من التوفيق بين المعتقدات تاريخ طويل في أنطاكية، ولا نزال نراه في مجموعة متنوعة من الخرافات والأساطير والتعويذات والارتباطات بالمواقع المهجورة.
ثمة مادة أسطورية كنعانية موجودة في مجموعات السحر التاريخيّة المصرية (القرنين الثالث عشر والثاني عشر قبل الميلاد) والآتية من بلاد الشام، تُظهِرُ تطابقاً بين إله السماء المصري المتعدد الأوجه «حورس»، وبين الإله الكنعاني «حورون». يمكن لهذا التطابق أن يوضح جذور الإيمان بـ «خارون» في العبادات التي سادت الشرق الأدنى. يعتقد المؤرخ القديم ديودور الصّقلّي أن رسول الموت واسمه يأتيان من مصر.
لكن الحقيقة هي أن الأمور أكثر تعقيداً من ذلك. فالوظيفة المقصودة لنصب «خاروون» الأنطاكي، الذي يلتمس عناية الآلهة ورحمتها، لا علاقة لها بـ «خاروون» الأساطير اليونانيّة، فالأخير هو المرشد الذي يقود أرواح الموتى من الأرض إلى الحياة الآخرة. ثمة تفسير آخر يقول أنه نظراً لأن النصب كان مخصصاً لإيقاف الوباء الذي أودى بحياة الكثيرين، يمكن أن يكون «خارون» قد احتاج إلى الاسترضاء عبر منحه دور المُرشِد إلى العالم السفلي لجموع الأنطاكيين الموتى الذين قضوا بعد إصابتهم بالوباء.
من الممكن أن يكون هناك خارونَين اثنين وليس واحد فقط، أم أنهما اتخذا شكلين مختلفين بعد انهيار العصر البرونزي؟ يبقى هذا السؤال دون إجابة، ولكن من المحتمل أن يكون الرّابط بينهما قد تولّد بعد فترةٍ طويلة من بناء النُّصب، وبعد أن أصبحت وظيفته الأساسيّة قد غرقت في غياهب النّسيان.
Fig 3. Old City, Antioch
يمكنني أن أحدّثكم مطوّلاً وبتوصيفات متنوّعة وغنيّة عن العنف الذي يسود في أرجاء هذه المدينة: محلات الهدايا التي تبيع تماثيل نصفية لملوك حثيين إلى جانب تماثيل نصفية لمصطفى كمال أتاتورك؛ المنفيون الأرمن الذين فرّوا إلى هنا بعد الإبادة الجماعية ومن ثمّ هربوا مرة أخرى نحو الانتداب الفرنسي في سوريا عندما تم ضم «هاتاي» إلى تركيا عبر إصدار استفتاء مزوّر؛ أشباح وسط المدينة، والخراب القديم أو الحديث الذي نراه على شكل منازل دمشقية أنيقة، كتذكيرٍ بأزمنة كانت أكثر لطفاً ورِقّة، لتتحوّل لاحقاً إلى أماكن ترفيهية تتنفس هواءً من الاغتراب المتصنِّع والزّائف. والقائمة تطول.
قدّم النظام الاستخراجي لعلم الآثار الإمبريالي نموذجاً لعمليات التنقيب التي جرت في ثلاثينيات القرن الماضي، والتي مَحَت ساحات وجدران الڤيلات الرومانية القديمة بالكامل، وصولاً إلى المتحف الأثري الذي أسّسته قوات الانتداب الفرنسي والذي اكتمل بناؤه لاحقاً في ظل الجمهورية التركية. تُرجم هذا العنف الاستخراجي إلى دورة من المصادرة والإبادة، وخلق جُزُراً من الانتماء والإقصاء المُحاطة ببِحارٍ وهميّة من القوة الغاشمة. في هذه الصفحة البيضاء المرشوشة ببعض المواقع الأثرية الصغيرة، والتي نجد أن الكثير منها مُختَلَق ومزوَر، يتم تسليح الوقت كأركيولوجيّة وطنيّة تشمل كامل التاريخ البشري، وتتوجّه غائياً نحو ولادة دولة قومية نبيلة وحديثة.
لكن هذه التوصيفات قد لا تفي بأي غرض، لأن محو طَمس كل ما ستسمعونني أقوله هو غاية في الاكتمال والشمولية بحيث أن المدينة تتوسّع مثل لوح فارغ يبتلع كل شيء في أعقابه، كنتيجة نهائيّة لتجربةٍ ديموغرافية استمرت قرناً من الزّمن. ما نراه هنا هو عمليّة محو لشعوب كاملة تواصل العيش كمجرّد هدايا تذكارية في المتاجر، أو كتشابهاتٍ غامضة، أو كجسامٍ جاثمة تطفو على مرتفعات سحيقة.
دُفِنَت أنطاكية الواقعة على على نهر العاصي عميقاً تحت المدينة الحديثة دون أي مدخل مرئي، ولا حتى إلى العالم السفلي. دُفِنَت أنطاكية عميقاً مثلما دُفِنَت مدينة «أرثوسيا» الرومانية. في عملهما النحتي الذي يحمل إسم «تحت مجرى النهر البارد» (2021)، يتوجّه كلٌّ من جوانا حاجي توما وخليل جريج إلى مخيم «نهر البارد» للاجئين الفلسطينيين الواقع على بعد 100 كيلومتر شمال بيروت، والذي دُمِّر في العام 2007 نتيجة الاشتباكات التي وقعت بين الجيش اللبناني ومجموعة «فتح الإسلام»، مما أدّى إلى تدمير جميع المباني في المخيم تقريباً، وتشريد آلاف الأشخاص.
مع بدء أعمال إعادة الإعمار، حصلت العديد من الاكتشافات الأثريّة التي كشفت النّقاب عن طبقات تاريخيّة متراصفة تمتد من العصر الحجري وصولاً إلى مدينةٍ رومانيّةٍ لا تزال محفوظة بشكلٍ جيد، إسمها «أرثوسيا». كان علماء الآثار يعملون عكس الزمن: تم اتخاذ قرار بردم المخيم بأكمله وإغلاق «أرثوسيا» باعتبارها ناووس، من خلال استخدام طبقات ضخمة من الإسمنت تتراوح سماكتها بين 50 سم و 4 أمتار. عمل حاجي توما وجريج هو دمغة من الناووس الذي دفن «أرثوسيا» بعد بروزها مباشرةً. وعلى غرار قول جريج في إحدى المقابلات التي تتطرأ لهذه المسألة: "سوف يتعيّن على «أرثوسيا» الانتظار حتى يتحرّر الفلسطينيون.
Fig 4. Under the Cold River Bed, Joana Hadjithomas & Khalil Joreige, 2021
هناك لاوصفيّة في اللغة عندما تتطرأ لهذه الكارثة التي تصمّ آذاننا عن السرديّة التي نعرفها. هنا، لم يعد من الممكن سرد قصص الأشياء كما هي وكما كانت دون الاخلال باستمرارية الحياة التي تقودنا عبر الواقع. تسأل سيمون فتال في نهاية نصها عن حركة السفر والتّرحال من وطنها الأم سوريا خلال العهد العثماني، "ماذا حدث لهذا المجتمع؟ ماذا حدث لبلادنا؟ أي نوع من الغضب والظّلم وقع علينا؟"
الطريقة التي نروي بها القصص، والقصص التي نختار أن نرويها، تحدد إلى حد كبير من نحن ومن نصبح من الوقت. هل من الممكن أن نكون بحاجة إلى الانتقال من التأريخ والتدوين إلى الخيال، وبالتالي العودة إلى الأسطورة والخرافة؟ أن تراودنا الإمكانية التخمينيّة بأن سردياتنا التأسيسيّة قابلة للتحوّل والانتقال من المصير إلى المقصد.
وهنا ندخل مرة أخرى إلى الأوديسة: أغنية عن رجل «معقّد»، في تأدية إميلي ويلسون لـتعددية التوجّه اليونانية (پوليتروپوس)، رجل بعقولٍ متعدّدة يمكنه أن يتّخذ أشكالاً مختلفة، والأهم من ذلك، من منظور التحليل النفسي، رجل يمكنه أن يغيّر طرائقه وأنماطه. هامَ أوديسيوس وضلّ طريقه بعد أن حاصر مدينة طروادة المقدسة، وعانى الأمرَّين في عواصف البحر وعمل على إنقاذ حياته وإعادة رجاله إلى ديارهم في «إيثاكا». لكن في هذه الأغنية التي تتناول فكرة العودة، كان لهذا البطل، وهو شخصية منقوصة ومعيبة إلى حدٍ كبير، القدرة على أن يفشل في كل شيء تقريباً. كوارثٌ وموتٌ وحطامٌ وخسارةٌ وحزنٌ لا ينتهي.
ومع ذلك، ففي الـ «أپولوجوي» (قصص داخل قصة) الواردة في الكتب 9 إلى 12 من الملحمة، يتولى البطل مهمة السّرد بدلاً من الشاعر ويروي قصته الشخصية للفايسيين، ويسرد لهم رحلته من طروادة إلى جزيرة أوجيجيا في كاليبسو. من خلال هذه السيطرة على السرد، يعيد رسم رحلته من متفرج خامل ومتألم مستسلم إلى شخص كامل يتمتع بالقوة والفاعلية. ولتحقيق ذلك، يلجأ إلى جميع الأدوات والطُّرُق النفسية والسردية: المبالغة، الحذف، الاستعارة، التلاعب، الكذب، التّفكيك الزّماني، الذاكرة الانتقائية والمحاكاة الساخرة.
يقدم لنا جويل كريستنسن قراءة لهوميروس من خلال عدسة العلاج السردي ما بعد البنيوي قائلاً أننا "نروي باستمرار قصصاً لأنفسنا وللآخرين لنعطي معنى ولنبرّر مكانتنا في العالم – غالباً ما تكون هذه القصص مشوّهة ومحرّفة ولكن دفاعية (وتعمل على حماية تقديرنا لذواتنا) [...] لذا، يمكن لعلاقتنا مع السرد أن تكون مؤشّراً على صحتنا العامة. أظهر الباحثون أننا غالباً ما نفقد القدرة على التحكم في السرد في أوقات الأزمات العاطفية والجسدية. بالنسبة لضحايا الصدمات، يمكن للذاكرة أن تصبح مثبّتة وأن تَخرُج السرديات الناجمة عنها عن السيطرة. في سياق سرد هذه القصص وإعادة ترتيبها وكأنها تُروى للمرة الأولى، يقدم أوديسيوس نفسه كرجل قادر على تغيير نفسه ومحيطه.
يروي أوديسيوس نفسه قصة قريبة من منتصف نص الـ «أپولوجوي»، يبدو أنها تقود سرديّة الخسارة، وعلى نحوٍ غير متوقع، في اتجاه جديد تماماً. في سياق القصة، يظهر حلّاً في أفق الاحتمالات: لقاء بين أوديسيوس وسيرس، إحدى المشعوذات، إبنة هيليوس إله الشمس، وحورية المحيط پيرسي.
بعد وصول أوديسيوس إلى جزيرة «أيايا»النائية، تقوم سيرس التي تعيش على الجزيرة بتحويل رجاله إلى خنازير، وبعد تدخل هرمس الذي جعله محصناً من تعويذاتها، يعيش أوديسيوس مدة عام مع سيرس في الجزيرة برفقة رجاله، يأكلون ويشربون ويستمتعون. تقول له: "أنت منهك وحزين ومكسور القلب، تعيش في ألمٍ وتيهٍ دائمين. لا يشعر قلبك بالسعادة أبداً. لقد تحملت الكثير."
بعد أن قضى عام هناك، أراد أوديسيوس العودة أخيراً إلى موطنه، ولكن، وللمرة الأولى، يتلقّى تعليمات واضحة وإنما مفجِعة: "حسناً، لكن عليك أولاً إكمال رحلة أخرى. إذهب إلى منزل هاديس والمريعة پيرسيفون، واطلب من رسول «طيبة» الأعمى تيريسياس نصيحته. فقد منحته پيرسيفون، هو وحده، البصيرة الكليّة، حتى في الموت." يجيب أوديسيوس مذهولاً: "لكن يا سيرس، من يمكنه أن يرشدنا في هذه الرحلة؟ لم يبحر أحد من قبل نحو منزل هاديس بسفينته." ولكن تعليمات سيرس كانت واضحة: "أربط سفينتك في المحيط الهائج، واذهب إلى منزل هاديس الفسيح. كلٌّ من پيريفلغتون وكوكيتوس، أحد معاوني ستيكس وقعا في نهر أشيرون.
ليس موضوعنا الآن ما حدث لأوديسيوس في العالم السفلي، ربما نتحدّث عن ذلك لاحقاً، ولكن يكفي أن نقول انه هناك فقط أصبج ممكناً للعودة أن تتحقّق، أي عندما اختبر الاستبطان والتفكّر الذاتيّ. هناك، أصبح بإمكانه الاستفراد بأخطائه وتصوّرها كجزء من سلسلة سببيّة كانت هي المسؤولة جوهريّاً عن معاناته، حيث يتعايش أوديسيوس مع نفسه كضحية وكمنتصر في جسدٍ واحد، وفي سرديّةٍ واحدة.
يمكننا أن نختتم قصتنا الآن على أنها «شبه خيال»، شبه خيال الانحدار إلى العالم السفلي: بعد أن فشلنا في تحديد موقع «خارون» عند نُصب «خارونيون»، لأنه من المحتمل أن يحمل الآن إسماً مختلفاً بالآرامية أو الأوغاريتية، وبدون أي آلهة محلية أخرى نلجأ إليها نظراً لأن الآلهة لا تسكن في المعابد المنهوبة، فقد توجّهنا إلى «وادي الموتى»، مسلّحين فقط بالتعليمات التي أعطتها سيرس لأوديسيوس. ولكن أي حَجٍّ إلى الأسفل هو ذاك الذي يبدأ بالصعود إلى جبل؟ ولماذا علينا الهبوط إلى العالم السفلي؟ من الضروري استحضار شبح، شبح صوفيا، الطائر الذي لاقى حتفه حديثاً. أردنا مساعدتها للوصول أخيراً إلى مدينة «أرثوسيا» الجاثمة على ضفاف نهر العاصي، والمدفونة عميقاً داخل ألواح سميكة من الإسمنت تحت هذه المدينة الحالية. هل هكذا إذن تبدأ رحلة الهبوط إلى العالم السفلي؟ في يوم صيفي جميل من شهر آب؟
من تعليمات سيرس، نعلم أن أشيرون، وهو أحد أنهار هاديس، والمرتبط بـ«خارون» بحسب العديد من المؤلفين، يقع في منطقة إپيروس اليونانيّة. ولكن، كيف يمكننا الوصول هناك دون تأشيرة سفر ومع دراجة ناريّة فقط كوسيلة تنقّل؟ من غير المؤكد ما إذا كان أوديسيوس قد حدّق في فراغ هاديس أم أنه سافر هناك جسدياً بالفعل، فإن تفاصيل الملحمة المتعلّقة بأسباب الرحلة تبقى شحيحة للغاية. فكّر أوديسيوس في خطة بديلة: ربما يكون هناك نهر آخر يُفضي إلى منزل إلى هاديس، نهرٌ إله، أو نهر الموت: معركة قادش، معركة قرقور، معركة إسوس، ومعركة الجسر الحديدي. وحديثاً، جار يقاتل جاره في الحرب الأهلية السورية: جورين ، جب الأحمر، العزيزية، السقيلبيه، قلعة المضيق، وغيرها الكثير.
سافرنا بعد ذلك إلى نهاية العالم المعروف، إلى أقصى طرفٍ في جنوب هذا البلد، عند مصب نهر العاصي في البحر، على خليج سلوقية پيريا، في مدينة السويدية الحديثة التي كانت معروفة بإسمها الأرمني «سڤيتيا». بعدما قام الأتراك بضم محافظة هاتاي، هاجر تقريبا جميع سكان القرى الأرمنية المجاورة إلى بلدة عنجر اللبنانية الواقعة بالقرب من اللبوة، حيث يولد نهر العاصي في شرق وادي البقاع. هكذا، ستكون الرّحلة أشبه بدورة كاملة من الحياة والموت. في الطرف الآخر من النهر، وقفنا عند الخليج الصامت، في الظلام الدامس، نحدق بعيداً في المجهول باتجاه ضوءين باهتين قادمين من سوريا، تلك المنطقة الحدودية الجديدة لعالم آخر، التي اخترقها القصف والتي شوهدت على بعدٍ من هذه النقطة بالذات، قبل فترة عامين فقط. في الصباح، غامرنا بالاقتراب من النهر، على حافة المحيط الهائج، على بعد بضعة كيلومترات جنوباً.
Fig 5. Seleucia Pieria
على الرّغم من ذلك، على الكاتاباسيس (الهبوط) أن يتبعه أناباسيس (العودة) لكي يُعتَبَر هبوطاً حقيقياً وليس مجرد موت. الأناباسيس هو العودة، أو الصعود إلى النور. يخبرنا دوغلاس فريم أن عودة أوديسيوس هي ليست عودة إلى الوطن فقط، بل أيضاً إلى النور والحياة. ليس من الضروري أن يقتصر الهبوط على العالم السفلي فحسب، بل هو يشمل أيضاً المناطق البائسة الرمادية مثل السّجن والتهجير والبُعد، حيث لا يعود للواقع أي معنى. تحدث غالبية عودة أوديسيوس في نهاية المطاف إلى مثل هذه الأماكن ، وبعيداً عن المشهد الأولمبي – أيوليا، تيليپيلوس، أيايا، سيلا وكاريپديس، أوغيغيا، شيريا.
لكن ماذا يعني أن نكون بعيدين في هذه المرحلة؟ بعيدين بالنسبة لماذا؟ هذا البحر القاسي الذي سيأتي منه موت أوديسيوس، وفقاً لتيريسياس، وقف أمامنا بهدوء بعد أن وصل إلى الحد الذي لا يمكن من بعده حتى الموت. هنا في بحر العالم السفلي، كل الأيام والليالي متشابهة، الجميع يصبح غير مرئي والوقت يتدفق بدون أي اتجاه.
ليس في نبوءة تيريسياس – على الرغم من احتوائها على معلومات عن موت أوديسيوس الذي حصل في ملحمةٍ أخرى نجهلها – أي ذكر عن عودته إلى الوطن! إنما هي الساحرة سيرس هي التي سوف تعطيه التعليمات الدقيقة، ولكن فقط من العالم السفلي.
لماذا تعيشون حياتكم في الظلام؟ تستفسر صوفيا مرة أخرى، وأخيراً، تقدم لنا إجابةً راسخة: في يومٍ من الأيام، في زمنٍ آخر، وعندما كنّا في طريقنا للخروج من أنطاكية على نهر العاصي، أخيراً غير مدفون، واعتماداً على وعد خليل بـ«أرثوسيا»، سيرس نفسها تنتظر «خارونيون» وتلقي علينا التحيّة مستخدمةً نفس الكلمات التي قالتها لأوديسيوس عندما عاد هو ورجاله من وادي الموتى: "يا للعجب! ذهبتم جميعاً أحياء إلى هاديس والآن ستموتون مرتين، بينما يموت الآخرون مرة واحدة فقط! تناولوا الطعام الآن، وامكثوا هنا لاحتساء الخمر طوال النهار، وعند الفجر، أبحروا. سأشرح لكم المسار بالتفصيل حتى لا يمسّكم شرّ، سواءً في البر أو البحر.
نحن الآن في انتظار لحظة الإبحار.
شكراً لكلٍّ من جويل كريستنسن، سيمون فتال، جوانا حاجي توما وخليل جريج، كارينا الحلو وباريش ياپار.