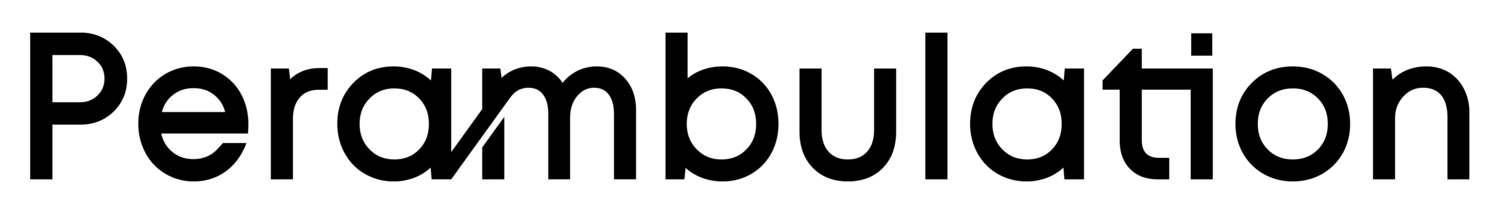مقابلة مع الفنّانين جوانا حاجي توما وخليل جريج
مقابلة مع الفنّانين جوانا حاجي توما وخليل جريج
نحب العمل مع الآخرين والتعاون معهم والاستقاء من نظرتهم وكلماتهم ومعرفتهم، سواءً كانوا من علماء آثار أو صحفيين أو جيولوجيين. تلك الأشعار هي في مركز الأعمال التي أنتجناها.
جوانا جاجي توما
Image 1. Waiting for the Barbarians, Animated photography, sound, multiples sources, video HD format, 4 min 26 sec
آري أمايا-أكرمان: لطالما كنت مهتمّاً بهذا الحوار لأنني أتذكر حوالي عامَي 2016 و 2017 عندما تحدّثنا جوانا وأنا عن مفهوم الجمال، وعن الحضور الدائم في المفاهيم الفلسفيّة المُعاصرة، لفكرة التحوّل التأويلي نحو تلك التساؤلات الجوهريّة المتعلّقة بالحقيقة والجمال والسّعادة وما إلى ذلك. اليوم، تعود تلك المفاهيك للظهور في هيئةٍ نصف يوطوبيّة، ذلك لأننا وصلنا إلى مُنتهى النّقد. وعلى الرّغم من أنّنا سبق وهدّمنا أسس نظرية المعرفة، إلّا أننا لا نزال نعيش في نفس العالم. هل السؤال هو إذن: إلى أين نذهب الآن؟
جوانا: نعم، بالضبط! لا أعرف ما إذا كنت تقصد الشيء نفسه، لكن ما شعرنا به في تلك اللحظة هو أننا قمنا بالفعل بتفكيك الكثير من الأشياء، وحاولنا العمل بشكل مختلف مع التصوير الفوتوغرافي ومع الأفلام، ولكن ماذا الآن؟ ماذا بعد ذلك؟
آري: نعم، هذا بالضبط ما قصدته! بعد انتهاء كل عمليات التفكيك، أين نحن الآن من حيواتنا التي نعيش؟
كارينا: أعتقد أن الشِّعر يَظهرُ اليوم، كما تقول، في لحظة مهمة جداً من حياتنا، لأننا نشعر بإمكانية وضرورة اللجوء إليه للنظر إلى الأشياء بطريقةٍ مختلفة، ذلك أن الواقع يصبح في بعض الأحيان ثقيلاً ومُرهقاً. أدركُ الآن بشكلٍ أفضل سبب إنتاجكما للفيلم بالتعاون مع إيتيل عدنان بعد اتخاذكما لأشعار قسطنطين كاڤافي كمرجع. لا يعود اهتمامكما بإيتيل عدنان فقط لأنها من إزمير، ولكن أيضاً لأنها شاعرة. ماذا يمكنكما أن تقولا عن تأثير شعر إيتيل عدنان على أعمالكما؟
Image 2. Ismyrna, Color, sound, HD video, 50min, 2016
خليل جريج: يتعلّق الأمر بمفهوم الوقت. تترك كل هذه المحادثات آثاراً ورواسب تعمل شيئاً فشيئاً على تشكيل نوع من الأرضيّة التي تمنحنا الخصوبة لكي تحدث الأشياء وتنبثق. لدينا دائماً أفكار ومشاريع ومحادثات أخرى مستمرة، حتى مع إيتيل مثلاً، إذ لا تقتصر أحاديثنا عن إزمير، فنحن نناقش أيضاً أماكن أخرى في الشِّعر تعطينا الانطباع بأننا نعمل على الأرض للاستشعار بأن شيئاً ما سوف ينمو انطلاقاً من هناك، أياً كان ذاك الشيء، أي بذرة نزرعها ونعمل عليها سوف تنمو وتزدهر لا محالة. لا يتعلق الأمر بقصيدةٍ فقط، بل هي وضعيّة وموقف، هو كائنٌ شعريٌّ تقابله. هكذا وفجأةً، يصبح كل ما تقوله إيتيل أو تنتجه مرتبطاً بالشِّعر.
كارينا: وهذا هو ما أراه جميلاً للغاية في منشوركما لمعرض «فراك كورسيكا». تتحدث إيتيل عن المِخيال وعن واقع أنها تعيش في هذا المكان الخيالي. عندما أرى تلك الأعمال، أشعر وكأنكما قد أعدتما خلق هذا المكان الخيالي القديم من خلال عيون الشعراء اليونان أمثال كاڤافي وسفيريس، وإيتيل ومدينتها الأم إزمير التي لم تعد موجودة كما هي في ذاكرتنا. هل شعرتما أنه من المهم تبيان هذا الأمر، أم أنه ظهر بشكل طبيعي وعضوي؟
خليل: ثمّة خطورة في اعتبار هذه الأماكن فُقّاعات مُسنَدة إلى مصادر خارجية. نحن نعيش في نوع من الحكاية الرمزية أو الاستعارة غير المرتبطة بأي شيء، وهذا أمرٌ نحاول دائماً تجنّبه، أي خطر المُكوث في عالم أسطوري. لا، نحن لا نزال في السياسة ولا نزال على اتصالٍ بالعالم المعاصر. هذا هو مفهوم «المنطقة»: لم نعد نستخدم مصطلح «كوزموبولي» بعد الآن، لأنه مصطلح مُحَمَّل بالعديد من المعاني والأبعاد، لكننا بدلاً من ذلك نستخدم مفهوم «المُعاصَرة». هذا يعني أن منطقة التحول من مفهوم جغرافي إنما هي دلالة مشاركة وقت أو زمن دقيق ومُحدّد. «المنطقة» هي زمان ومكان، لكننا نركّز تحديداً على فكرة الوقت هذه.
آري: عندما تتحدث عن مفهوم «المُعاصَرة» هذا، فهو مرتبط بالتجارب اللامُهيمِنة في بلد مثل لبنان وتركيا، والتي رأيناها أيضاً في العديد من الأماكن الأخرى مثل كولومبيا، حيث وُلدت أنا. هناك دائماً فكرة فلسفية مفادها أن المفهوم الهرمي والخطّي للوقت قد انهار، وقد وُضِعَت العديد من النظريات حول هذه الفكرة منذ منذ القرن التاسع عشر، ولكن في الواقع، نحن نعيش تجربة سياسية مباشرة لهذا الانهيار تتعلّق بكيفيّة عيشنا في هذا الكون ذي الزَّمانيّة المكسورة لفترة طويلة. غير أننا لا نحاول بالضرورة إصلاح هذا الوقت، لذلك أعتقد أنه وفي الكثير من هذه الأعمال التي نناقشها، هذا الشعر، هؤلاء الفنانين، ما نحاول القيام به هو وصف هذه التجربة بشكل أكثر دقة.
جوانا: بالضبط، أعتقد أيضاً أننا لم نختر أي شعراء فحسب، بل هم شعراء شكلّوا جزءاً من هذا النقاش، وهم على ارتباطٍ أيضاً بفكرة الدولة العثمانية وانهيارها. هذا هو أحد الجوانب التي ربما لا نتناوله بشكل مباشر، ولكنه ليس بعيداً جداً عن محور عملنا. ذلك لأننا نشعر أننا نعيش لحظة تتغيّر فيها الكثير من الأشياء في المنطقة، وقلّة قليلة فقط يتحدثّون عنها ويخاطبونها، بما في ذلك المؤرخين. أنا وخليل مهتمّان بهذا النوع من الاستمرارية الزّمانيّة، لذلك عندما نستخدم قصيدة كاڤافي مع الصُّوَر التي ننتجها اليوم، والمرتبطة بما يحدث في لبنان، فإننا نربط بين حالتَين ولحظتَين وزمانيّتَين. ومن خلال ربط هاتين الزّمانيّتَين، نشعر أننا نحاول أيضاً استيعاب المزيد حول الماضي والحاضر الذي نعيشه. لكن الأمر لا يتعلّق فقط بعمليّة إعادة تنشيط، فعندما نقول إننا نستعير نظرات وكلمات الآخرين وننخرط في حوار معهم، حتى لو لم يكونوا حاضرين معنا، إنما نفعل ذلك لتكريمهم والثّناء على مسيرتهم. عندما لا يُدَوَّن التاريخ، تُنسى الأسماء بسهولة.
خليل: الجسور مكسورة، وإذا عدنا إلى ما قلته عن الانقطاع الزّمانيّ، نتذكر مقدمة كتاب «أزمة الثقافة» لـ حنّة آرنت، والتي تتحدّث فيها عن الماضي الذي يندفع قُدُماً لكن دون إمكانيّة التقدّم والاستمرار في نفس الوقت، حيث نجد أنفسنا عالقين بين الماضي والمستقبل في حالةٍ من التصدّع والانقطاع. ندرك أنفسنا في هذه التصدّعات، إذ نشعر أننا في منتصف جسر حيث لا يمكننا الرّجوع ولا التقدّم لأن شيئاً ما قد انكسر، لأن هناك حادثة قد وقعت أو أن قذيفة تمنعنا من الاستمرار. لذا، علينا هنا أن نبني شيئاً آخر جانباً لنتمكّن من المُضيّ قُدُماً، أو أن نتخيّل أنه علينا القفز والسباحة بعد سحب شيء إلى الخلف.
جوانا: أنتَ تستخدم كلمة «لا مُهيمِن»، بينما نحن نقول «مُتَعاصِر» لنتحدث عن تصوير المِخيالات وبنائها: علينا أن ننتج صُوَرنا الخاصة، وما قاله خليل عن الجسر الذي تتحدّث عنه حنّة آرنت، يرجع إلى فكرة المكان الذي يجب أن نقف فيه. هو مكانٌ مُربِك وغير مريح حيث تمزّقنا الزّمانيّات والنّزعات والتّحرُّكات.
خليل: علينا أن نقبل أن نكون في مكانٍ لاقوّة ولكن ربما ذي تأثير. في مكان نفوذ. عندمت تحدّثت جوانا عن التّكريم والثّناء، كانت فكرتها تتعلّق بالاعتراف بأن التأثيرات، في بعض الأحيان، ستكون قادرة على بناء نوع مختلف من شبكات اللاقُوّة. التحوّل من القوة إلى التأثير.
Image 3. Where is my mind, video installation, 2020
آري: مؤخراً، قرأت في كتابات عالم الآثار غاڤين لوكاس الذي يقول: "السّجل الأثري يشبه الطِّرس رق الممسوح الذي يُكـتَبُ عليه أكثر من مرة)، هو البقايا التراكمية للعديد من الأحوال والسّوائر السّابقة، وهو لا يعكس أي لحظة محدّدة". جعلني هذا أفكر في مشروعكما بالعلاقة مع اللاتوافقات الجيولوجيّة، والآن بينما كنت أفكر في عواقب الوقت، فإن النتيجة ليست ملساء أو متجانسة. تتحدث حنّة آرنت عن إمكانية الفعل، والقدرة على البدء من جديد، والانطلاق، واستئناف الأشياء وإعادة تشغيلها. جوانا: الطُّروس، كما تعلم، حاضرة جداً في أذهاننا. يبدو كما لو كانت جميع الأزمنة السابقة حاضرة معاً. بالنسبة لنا، فإن الحالة الأكثر ذهولاً التي تناولناها هي حالة مخيم اللاجئين الفلسطينيين في «نهر البارد»، الذي دمره الجيش ومجموعة «فتح الإسلام» في العام 2007. عندما حاولوا الشّروع في عمليّة إعادة الإعمار وإزالة الأنقاض – لأن المخيّم كام مدمّراً بالكامل – وجدوا تحت أرض المخيّم أنقاض مدينة «أورثوسيا» الرومانية. كانت المدينة جاثمة هناك طوال الوقت.
آري: عندما يتحدّث كلٌّ من جوانا وخليل عن النوستالجيا، وبالنظر إلى المكان اللذان يعملان فيه، يبدو لي كما لو أن النوستالجيا دائما ما تكون محافظةً سياسياً. وبالنسبة لي، أن أقول هذا بصفتي شخص يتعامل كثيراً مع مادة العصور القديمة ومع مفهوم القِدَم، فإن أي كلاسيكيّة هي استعادةٌ وإحياء، هي استعادةٌ للنظام والترتيب والتّنسيق. في أعمالٍ مثل «أين عقلي»، هناك شيء يأتي من الماضي، ولكننا ندرك أن في هذا الماضي شيئاً من العيش في الحاضر، والحاضر لطالما سيكون مهدّداً بالخطر. لا وجود لمكان آمن حقيقي، علينا أن نقف على حافة الهاوية لنرى من نحن بعيداً عن البناء التاريخي.
جوانا: نعم، بالضبط، أوافقك الرأي! بالنسبة لي، هذه التماثيل هي شديدة المُعاصَرة، فهي تحمل معها الماضي والحاضر والمستقبل. إنها تماثيل آتية من الماضي، ولا شك أن علم الأركيولوجيا يثمنّها ويقدّرها على أنها آثار، لكن بالنسبة لي اليوم، هي موجودات معاصرة تماماً. وانت فكرة النوستالجيا المحافظة حاضرة جداً عندما بدأنا، خليل وأنا، في إنتاج صُوَر وتجهيزات تهدف إلى محاربة هذه النوستالجيا.
كارينا: أودُّ العودة إلى فكرة مشاركة المُعاصَرة. كان خليل يقول أننا لا نتشارك الوقت نفسه فقط، بل أيضاً الزّمن نفسه. مع الطَّواف، نحن مهتمون بهذه المناطق (اليونان، لبنان، تركيا...) وكيف يقوم التاريخ بربط الأشخاص المختلفين معاً في هويات غير متبلورة ومتقلّبة ومتعدّدة الجوانب والمظاهر بحيث يصبح استيعابها أمراً عسيراً. مع ذلك، فنحن لا نزال نتشارك المِخيال ذاته. كيف تنظران إلى هذا الجزء من المنطقة في عملكما؟ بما أنكما تحدثتما، مثلاً، عن الحقبة العثمانية والآثار اليونانية والأركولوجيا في بيروت، كيف تربطان كل هذه الأشياء معاً؟
جوانا: لستُ متأكدة من الإقرار بأن كل الأشياء مترابطة ببعضها البعض. يتعلّق الأمر بالاستمرارية والاتصال. ربما يكون هذا هو موضوعنا الحقيقي: كيف نمثل أنفسنا؟ من أين نستمد التأثيرات، ومن أي منطلق أو وجهة نظر نتحدث؟ لا شك أن أعمالنا مرتبطة بالجغرافيا، ولكن بالنسبة لنا، الأمر يُعنى بكيفية تحرير أنفسنا من القومية ومن المحافظية ومن التمثيل الاستعماريّ. في منطقتنا، نقوم طوال الوقت بإعادة إنتاج الكثير من التمثيلات الاستعمارية أو المناهضة للاستعمار. لكن، ما هي صُوَرُنا؟ ما هي الصُّوَر التي نصنعها كأشخاص هنا، في هذه اللحظة. أعتقد أن الجغرافيا التي تتحدثين عنها، بالنسبة لنا، هي أشبه بحيّزٍ للفن والأفلام. هنا نتشارك منطقة أخرى. أراضينا متجذرة جداً في واقع المنطقة، لكننا نحاول أيضاً العمل في منطقة مختلفة من شأنها أن تربط الأعمال الفنية والأشخاص والاهتمامات.
آري: يبدو الأمر كما لو أنكما تبحثان وتستكشفان وتنقّبان إلى أن تقعان فجأة على مكان صانعٍ للحقائق. وأنا مقتنع بأن جميع الاكتشافات الصّانعة للحقائق هي في ماهيتها أفعال سياسية تتجاوز فضاءها الثقافي والتاريخي.
جوانا: لا يمكن لأعمالنا أن تكون مجرّد ردّة فعل، علينا أن ننتج صُوَرنا الخاصّة. وهذا مهم جداً. علينا أن ننتج سرديّاتنا الخاصّة، سرديّاتنا الممكنة والمحتمَلة. لأن هذه أيضاً هي الطريقة التي نعيد بها صياغة وضبط علاقتنا بالعالم.
خليل: أن نبقى في هذه المنطقة، أو في هذه الأماكن المُربِكة وغير المريحة حيث لسنا الفائزين، وحيث لسنا الأغلبية.
جوانا: لكننا لسنا الضحايا أيضاً!
خليل: نرفض أن نكون الضحايا! ومن خلال هذا الرّفض، ما نصبو إليه هو التَّفرُّد، نحن نصبو إلى تمثيلنا الخاص لأنفسنا. إذا كنّا عاجزين عن إنتاج صورنا الخاصة، سنقوم ببساطة بإعادة إنتاج صورة الآخر.
جوانا: بعد الانفجار، بدأت العمل على أسطورة «أورفيوس». أثار أورفيوس اهتمامي بسبب فكرتين ظهرتا بعد أن توقّفتُ عن البكاء المتواصل. كانت في ذهني صورة أورفيوس الذي مزّقت جسده الباخيات وتبعثرت أطرافه في كل أرجاء العالم. وأعتقد أن هذا هو الانطباع الذي شعر به كل واحد منّا عندما كنّا داخل نيران الانفجار. إنفجرتُ داخلياً، إنفجرتُ في أحشائي. رأسي في مكان وقدميَّ في مكان آخر، جسدي مُخَلَّع ومُقَطَّع. ولكن بعد ذلك، ظهرت فكرةٌ أخرى: عندما عاد أورفيوس لإحضار يوريديس، فقد فعل ذلك عن طريق الموت، وعندما نعود من الموت، نتغيّر ونتحوّل. سَبَق وأن عملنا مع خليل على هذه الفكرة من قبل، وكتبنا كثيراً عن أولئك الذين يرتكبون عمليات انتحارية، وكنّا قد كتبنا سابقاً رسالة تقول «أنا هو»، ربيع مروة. لقد عملنا على فكرة «أنا هذا الشخص، ومُتُّ من أجل كذا». لكن البعض منهم يفشلون في عمليّة قتل أنفسهم ولا يموتون. فهل يمكنهم أن يظلّوا هُم أنفسهم بعد قول عبارة «لقد مُتُّ»؟ هذا هو التحوّل الذي يجب التحقّق فيه، أي عندما تقول "حسناً، لقد عدتُ وسوف أُحدِثُ تغييراً، سوف أفعل شيئاً". يجب أن نكون فعّالين ونشطين. كان هوسي هو أن أظل فاعلة بالعلاقة مع ما حدث.
خليل: وتحويله.
جوانا: وتحويله إلى شعر. كان رأس أورفيوس، على الرّغم من كونه مقطوعًا بالكامل عن جسده، لا يزال يتلو الشِّعر ويغنّي.
كارينا: هل ستستمرين في التحديق في الجمال مطوّلاً؟
جوانا: حتماً! هذا المشروع هو بالفعل مشروع مستمر. نحن بحاجة إلى مواصلة التحديق في الجمال! إنها فكرة التحديق بعُنف.
آري: ما كنت أفكر فيه هو أنني عندما عدتُ من اسطنبول إلى موسكو بعد الهجوم الإرهابي المُريع على ملهى «رينا» الليلي في كانون الثاني/يناير العام 2017، كان عاماً كارثياً بِحَق على تركيا. ثم تذكّرت حديثي مع جوانا عندما قال لي: "عليك أن تتذكر الضوء!"، الضوء الذي يسطع في عمل جوانا وخليل الذي رأيناه معاً في الشارقة في العام السابق. وبعد ذلك أتى عمل «رسالة إلى مارغريت دوراس»، الذي جعلتني أفكّر بالطريقة التي قمتِ بها بوصف مدينة بيروت اليوم قبل أن نبدأ المقابلة. أخبريني عن الليل والنهار، عن النهار والضّوء، أين نحن اليوم أو إلى أين نتجه من هنا؟
Image 4. Remember the Light, 2016, Color, sound, 2 HD videos, 8min
خليل: تتمدور الفكرة حول فعل إضافة الضوء، الضوء الاصطناعي. أن نستعير الضوء من مكان آخر، في مقابل هذا التضاؤل في الألوان. ولكننا بدأنا هذا العمل قبل أن يتحوّل البحر الأبيض المتوسط إلى المقبرة المفتوحة التي نراها اليوم. لذلك عندما صوّرنا العمل بينما كان كل هؤلاء الأشخاص يغرقون في البحر، تكوّنت لدينا دلالات مهمّة، إلّا أنها ساقَت العمل نحو تأويلٍ واحد.
جوانا: ومع ذلك فإن هذه الدلالات تبقى حاضرة بشدّة. هي موجودة في إزمير وفي «تذكّر الضوء» بطريقةٍ مباشرة للغاية. هناك الكثير من الأشكال والتّكوينات المتكررة في «لقد حدّقت في الجمال مطوّلاً»، الشّموس المتعدّدة، الفوضى، أولئك الأشخاص الذين هم نحن، جدّي على متن القارب... يمكن لعمل «رسالة إلى مارغريت دوراس» أن يكون جزءاً من تلك المحاولات الشعرية، لأنها شخصية محورية جداً بالنسبة لي. عندما اقترحت علينا «E-flux» العمل على هذا الفيلم، كان علينا أن نقدّم شيئاً يردّد صدى فيلم شخص آخر. وكنّا جوانا وأنا قد شاهدنا فيلم «الأيادي السّالبة» قبل ذلك بقليل، تحديداً في اليوم الأول من الإغلاق العام بسبب جائحة كوڤيد-19. «الأيادي السّالبة» هو نص وفيلم جميلٌ للغاية تتحدث فيه دوراس عن شخص ما، عن امكانية الحب وعن امكانية الضّوء، تتحدث بأسلوبها الخاص والرائع عن اللحظة التي يخرج شخص ما من مجموعة ما كما في المأساة اليونانية، ويبدأ في البَوح . يبدأ في التعبير عن شيءٍ يولّدُ شيئاً ما، وعندما يخرج هذا الفرد من المجموعة، في تلك اللحظة، ينبثق احتمال الحب، واحتمال حدوث شيء ما. لقد عملنا لسنوات عديدة على فكرة خروج الفرد من المجموعة ومن المجتمع، في لبنان حيث يرتبط كل شيء بالمجتمع. كما عملنا كثيراً على فكرة الشّخص الذي يخرج من المجموعة ويقول «أنا». نتحدث دائماً عن فكرةٍ لـ جيل دولوز تتمحور حول الأسباب التي تجعلنا نؤمن بالعالم، علينا أن نجد أسباباً لمواصلة الإيمان بالعالم. والجمال هو جزء من الأشياء التي تمنحك أسباباً للاستمرار في ذلك.
قالوا لنا ستنتصرون عندما تحبّون. أحببنا وكان لنا الرَّماد.
قالوا لنا ستنتصرون عندما تهجرون حياتكم. هجرنا حياتنا وكان لنا الرَّماد.
كان لنا الرَّماد. رمادٌ سيمكث هاهُنا لإعادة اكتشاف حياتنا،الآن، بعد أن فقدنا كل شيء.
جورج سفيريس
السيد ستراتيس يصفُ رجلاً،
قصائد مُجَمَّعة، (1924-1955)
ترجمه كيلي إدموند وشيرارد
يتفكّر الفنانان والمخرجان جوانا حاجي توما وخليل جريج في الصُّوَر والتمثيلات وفي بناء المِخيالات وكتابة التاريخ. تسعى أعمال الفنّانين إلى خلق روابط موضوعية ومنهجيّة بين التصوير الفوتوغرافي والفيديو والفن الأداء والتجهيز والنحت والسينما، سواءً وثائقيًة أو روائيّة. أخرَجا معا العديد من الأفلام التي عُرِضَت ومُنِحَت أهم الجوائز في أبرز المهرجانات السينمائية الدولية، قبل إطلاقها في صالات العديد من الدول. من أفلامهما: «إسميرنا» (2016)؛ «النادي اللبناني للصواريخ: لبنان يغزو الفضاء» (2012)، الذي حاز على العديد من الجوائز، منها جائزة أفضل فيلم وثائقي في «مهرجان الدوحة ترايبكا السينمائي» في قطر؛ «خيام 2000 - 2008» (2008)؛ «أريد أن أرى» (2008) مع كاترين دونوڤ وربيع مروة، والذي عرض للمرة الأولى ضمن قائمة أفلام الاختيار الرسمي لمهرجان كان السينمائي في العام 2008، وحصل على جائزة أفضل فيلم منفرد من نقابة النقاد السينمائيين الفرنسية؛ «يوم آخر» (2005)، الذي عُرِضَ للمرة الأولى في «مهرجان لوكارنو السينمائي الدولي» ومُنِحَ جوائز عديدة منها جائزة الاتحاد الدولي لنقّاد السينما (فيپرسكي)؛ «الفيلم المفقود» (2003) و«البييت الزهر» (1999). تم عرض العديد من أفلامهما ضمن برامج نظّمتها معاهد ومؤسّسات مشهورة مثل «سينماتك» (بروكسل)، «منتدى فلاهيرتي للسينما» (نيويورك)، «المعهد الفرنسي» و«متحف موري للفنون» (توكيو)، «مهرجان خيخون السينمائي الدولي» (إسبانيا)، «أرشيف هارڤارد للسينما» (كامبريدج)، «مركز لينكولن» (نيويورك)، «مهرجان لوكارنو السينمائي الدولي» (سويسرا)، «متحف الفن الحديث، MoMa» (نيويورك)، «باريس سينما» و«متحف تيت مودرن» (لندن) و«رؤى الواقع» (نيون). سيصدر فيلمهما الروائي الأحدث الذي يحمل عنوان «صندوق الذاكرة» في العام 2021. إشتهر الفنانان بأبحاثهما الطويلة المدى المرتكزة على وثائق شخصية أو سياسية، مع اهتمام خاص بآثار التاريخ المحجوب والغائب والتواريخ المخفيّة والمحفوظة في طيّ الكتمان، مثل حالات الاختفاء القسري خلال الحرب الأهلية اللبنانية، برنامج الفضاء اللبناني المنسي من ستينيّات القرن الماضي، والعواقب المذهلة وغير المألوفة لعمليات الاحتيال عبر الإنترنت والبريد الإلكتروني، أو الأنفاق الجيولوجية والأثرية للمدن وحركتها السريّة. من بين أعمالهما الفنية الرئيسية: «دائرة الارتباك» (1997)، «صُوًر دفينة» (2003)، «النادي اللبناني للصواريخ» (2011)، «عن الخداع» (2014)، «لقد حدّقت في الجمال مطوّلاً» (2016) و«مخالفات» (2017)، التي عُرِضَ في «مركز جورج پومپيدو» (باريس) وحصل على جائزة مارسيل دوشامب المرموقة.